اقتصاد متهالك دمرت الحرب ما تبقى منه.. هشاشة البنية التحتية وتحديات التنمية في اليمن
ألقت الحرب المشتعلة في البلاد للعام الثامن على التوالي، بتداعيات جمة، على العديد من مظاهر الحياة في البلاد، سيما الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وقطاعات البنية التحتية.
وأدى تضرر المرافق الحيوية، وشبكة البنية التحتية، إلى تراجع حجم نشاط الاقتصاد الوطني، بشقية العام والخاص، وتضاءلت فرص التنمية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي، وتراجع مستوى المعيشة.
وللأهمية البالغة التي تلعبها البنية التحتية لأي اقتصاد في العالم، في التوجه نحو الاستقرار والنمو، فإن دراسة احتياجات البلاد في هذا الجانب، وتركيز الجهود نحو إصلاح المرافق الحيوية والاقتصادية، وشبكة الطرق والجسور، ومياه الشرب والري، وقطاع الكهرباء، وتحسين القطاع الصحي، تمثل نقطة البداية والانطلاق، لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق التعافي، وتحسين الوضع المعيشي لليمنيين.
وتأتي أهمية البنية التحتية من الآثار التي تتركها على البلد بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص، وبالتحديد مسألة النمو الاقتصادي وتوليد الفرص، لانعكاسها بشكل واضح على الاستقرار الاقتصادي، بل اعتبرها البعض مفتاح النمو الاقتصادي وفرص العمل، إذ لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي، دون تقدم ملموس في جودة البنية التحتية فضلاً عن وجودها في بداية الأمر.
خلال الوضع الراهن في بلادنا، أشار البنك الدولي، عبر تقرير الآفاق الاقتصادية لليمن، إلى أن تعطل مرافق البنية التحتية والخدمات المالية، أثر تأثيراً حاداً على نشاط القطاع الخاص، كما أن أكثر من 40% من الأسر اليمنية تجد صعوبة في شراء حتى الحد الأدنى من غذائها وفقدت أيضاً مصدر دخلها الرئيسي.
وكان الفقر يتفاقم حتى قبل الحرب، حيث طال نحو نصف سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 29 مليون نسمة.
وبات يؤثر الآن على ما يقدر بنحو 71% إلى 78% من اليمنيين، مع ملاحظة أن النساء يمثلن الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من سكان اليمن.
لذا فإن معالجة القطاعات التي دمرتها الحرب، وتشوبها الكثير من الاختلالات، مثل شبكة الطرق وقطاع الكهرباء، ومياه الشرب والري والصرف الصحي، ضرورة قصوى لأي محاولات أو جهود، نحو الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، ومعالجة الخدمات العامة، للمواطنين.
اختلالات قطاع الطاقة
وأمام الأوضاع التي أفرزتها الحرب، تحضر تحديات أساسية، أمام إعادة تنمية البلاد، تتمثل أبرزها في قطاع الكهرباء، حيث يأتي هذا القطاع، في طليعة القطاعات المتضررة من الحرب في اليمن، بالذات المناطق التي كانت تحصل على التيار من الشبكة الموحدة قبل اندلاع الحرب بشكل أوسع عام 2015، فقد شهدت إما تدمير بنيتها التحتية أو تعذر حصولها على الكهرباء نظراً لانخفاض قدرات التوليد على الشبكة الرئيسية.
وبات قطاع الكهرباء حالياً مع زيادة الاختلالات فيه، يُشكل بؤرة استنزاف للخزينة العامة للدولة، نتيجة تضخم فاتورة توفير وشراء الوقود لمحطات التوليد، الأمر الذي يتطلب رفع وتيرة الإصلاحات الخاصة في إجراءات الشراء وتعزيز آليات الرقابة على الإنفاق.
تنفق الحكومة اليمنية، نحو 1.2 مليار دولار سنوياً لشراء الوقود الخاص بتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما يجعل فاتورة الإنفاق المتضخمة بمثابة هدر وتسرب مالي، بدون فوائد واقعية بالإمكان تحقيقها في ظل معاناة البلاد، وحاجتها الماسة للموارد المالية لتغطية تكاليف الإنفاق على تحقيق الاستقرار النقدي وفاتورة الغذاء وبقية الاحتياجات الضرورية.
قبل اندلاع الحرب، كان معظم سكان اليمن محرومين من خدمات الكهرباء الأساسية، فقد كانت اليمن تعتبر من بين البلدان الأدنى مستوى من حيث توفر الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تراوح معدل الحصول على الكهرباء قبل الأزمة من داخل الشبكة الوطنية وخارجها بين 52% و72 % في عام 2014م، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفقر.
وقد بلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في البلاد 217 كيلو وات في عام 2014م، أي أقل من سدس المتوسط في الإقليم، وبلغ العرض المقدر للطاقة خلال عام 2015م 519,1 ميجاوات.
كما كان هناك اختلال كبير بين العرض المقدر بحوالي 519,1 ميجا وات، وبين الطلب حيث كانت قدرة العرض تقل عن ذروة الطلب بنسبة 20 %.
وعلى الرغم من الإعانات المباشرة وغير المباشرة الكبيرة، لم يتمكن القطاع من توليد طاقة كهربائية بتكلفة ميسورة ويمكن الاعتماد عليها وبالقدرة الكافية اللازمة للحفاظ على النمو الاقتصادي، كما لم يتمكن من توسيع تغطية خدمات الكهرباء على نحو مستدام وتوصيلها إلى المناطق الريفية.
وشهد العمل في قطاع الطاقة، تباطؤاً شديداً، فالمنشأة الرئيسية والوحيدة لتوليد الطاقة التي تمكنت المؤسسة العامة للكهرباء، من إنجازها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية هي محطة مأرب الغازية بقدرة 340 ميجا وات والتي تم التعاقد على بنائها في عام 2005م ودخلت الخدمة في عام 2009م، ولم يتم إكمال سوى 200 كم من خطوط نقل الطاقة 400 كيلو فولت و 185 كيلو متر من خطوط نقل الطاقة 132 كيلو فولت بين عامي 2004م و 2015م.
ونتيجة لاعتماد الحكومة على محطات توليد قديمة تعمل بالديزل، وزيوت الوقود الثقيل، باستثناء محطة مأرب الغازية، فقد أدى هذا الأمر، إلى زيادة تكاليف التشغيل، نتيجة الاستهلاك الكبير لمحطات التوليد التي تعمل عبر الديزل والوقود.
تفاقمت الاختلالات في قطاع الكهرباء، مع توسع دائرة الحرب في اليمن، وطول أمدها، الأمر الذي كان له تداعيات وخيمة على قطاع المياه والصرف الصحي، وبالتالي الصحة العامة، كما انخفضت نسبة السكان اليمنيين الذين يحصلون على الكهرباء العامة من 66 % في عام 2014 إلى أقل من 10 % بحلول نهاية عام 2017م، وفق إحصائيات صادرة عن البنك الدولي.
ويمكن إيجاز أبرز العوامل والأسباب، التي أدت إلى ضعف الشبكة العامة للكهرباء في البلاد، بنقص الوقود في المدن التي تعمل فيها الشبكة العامة، حيث أثرت أزمة الديزل أيضاً بشكل كبير على أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي.
ونظراً لعدم توفر موازنة مركزية منذ 2014م، أدت الصعوبات المالية إلى الحد من قدرة المؤسسة على إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين، فضلا عن سوء تحصيل فواتير الكهرباء والربط غير القانوني إلى مزيد من الضغوط على المؤسسة العامة، إضافة إلى عدم التشغيل السليم والصيانة.
وفي ظل عدم توفر مستوى يعتمد عليه من إمدادات الكهرباء العمومية أو وقود الديزل، أصبحت الطاقة الشمسية آلية شائعة للتكيف في كل من القطاع الخاص والعام.
وتشير تقديرات تقييم السوق أجري في 2016 بتكليف من البنك الدولي، إلى أن معدل انتشار الطاقة الشمسية في السوق واستخدامها لأغراض الإضاءة أو تشغيل الأجهزة بلغ 75 في المائة من المنازل في بعض المناطق الحضرية، بما فيها صنعاء حيث الحاجة لمكيفات الهواء تعتبر منخفضة بصورة عامة.
وبنهاية 2019، استخدم ما يعادل 75% من الأسر في جميع أنحاء البلاد أنظمة الطاقة الشمسية كمصدر أساسي للكهرباء، مع وجود حصص أكبر في المناطق الريفية وفي الشمال، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن البنك الدولي.
ويشير مسح آخر، أجراه برنامج الأغذية العالمي مؤخراً في نوفمبر 2017م إلى أنه في 14 من أصل 22 محافظة، كانت الطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي للطاقة المنزلية، وأن أنظمة الطاقة الشمسية أصبحت تُعتمد بشكل متزايد في قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي، وغالباً ما تدعمها منظمات غير حكومية أو المنظمات الدولية الأخرى.
وتُقدر الأضرار المادية التي لحقت بالهياكل الأساسية لشبكة الكهرباء الحضرية في المدن، التي تم تقييمها بمبلغ يتراوح بين 422–516 مليون دولار أمريكي، طبقا لإحصائيات سابقة للبنك الدولي.
تفتيت أوصال البلاد
أمّا في قطاع النقل، فقد أدى تضرر شبكة الطرق والجسور، والموانئ والمطارات، إلى تفتيت أوصال البلاد، وتفاقم صعوبات التنقل للمواطنين، وحركة نقل البضائع والسلع، والحركة التجارية بين المحافظات.
وتعرض ما نسبته 29٪ من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، و511.1 كيلومتر لدمار كلي، مشيرة إلى تقديرات عن خسائر بمليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي.
وقالت دراسة حديثة إن الحرب أثّرت في البنية التحتية لقطاع النقل بشكل كبير، وأدت إلى تضرر الطرقات والجسور والموانئ والمطارات، وتعرض ما نسبته 29٪ من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، و511.1 كيلومتر لدمار كلي، مشيرة إلى تقديرات عن خسائر بمليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تعرضت 50٪ أو أكثر من البنية التحتية لشبكة الطرق في مدن الحزم وتعز وصعدة ومأرب للضرر.
ويشير تقرير تقييم الأضرار الذي أجراه صندوق صيانة الطرقات، إلى أن ما لا يقل عن 1241 كلم من الطرق تضررت بشكل كبير في محافظات صعدة وعمران وصنعاء وتعز وأبین ولحج، وتوقفت العديد من مشروعات الطرق الريفية وعقود صيانة الطرق والجسور، ما عطّل الكثير من فرص العمل وكسب الدخل.
وعمل حصار مليشيا الحوثي، على مدينة تعز، وإغلاق كافة الطرق والمنافذ الرئيسية، إلى خنق المدينة، والتسبب بمأساة إنسانية، وخسائر اقتصادية بالغة لحقت بالمؤسسات العامة والخاصة وزيادة الأعباء على المواطنين.
ويقدر إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطرق داخل المدن، بما في ذلك إنارة الشوارع في 16 مدينة ما بين 240 و293 مليون دولار، وتراوحت الأضرار التي لحقت بقطاع النقل من الطرق داخل المدن أو الطرق الطويلة التي تربط المدن ببعضها، والجسور والموانئ والمطارات بـ780 و953 مليون دولار أميركي.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكاليف الأضرار في قطاع النقل البري والجسور تقدر بنحو 500 مليون دولار أميركي.
الفقر المائي
في الجانب الآخر تبرز قضية المياه، وهي أزمة قديمة جديدة، تزداد حدتها ومخاطرها، مع غياب الحلول من الجهات المعنية، وتداخل المشكلات والمعضلات مع القطاعات الأخرى، وهي من التحديات التنموية، حيث فاقمت الحرب أزمة المياه، من وآثارها السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بشكل عام.
وتُعتبر اليمن، من أكثرِ البلدان التي تعاني من نُدرة المياهِ على المستوى العالمي، حيث يواجه معظم السكان خطراً وجودياً، يتمثّل في نُدرة المياه، وتبرز أهمّ مظاهرِ أزمة المياه، في نضوب المياه الجوفية، والتغييرات المناخية، التي تؤثر على معدلِ كمية احتياطِي المياه في اليمن، إضافة إلى الاستهلاك العشوائي والمتزايد لمزارع القات وغيرِها، وحفرِ الآبارِ بشكلٍ غيرِ مدروس.
وخلال الفترة الأخيرة، تشير العديد من التقاريرِ الدولية، إلى تراجع حصَّة الفرد من المياهِ، سنوياُ مقارنة بالأعوام الماضية.
ويعد القطاع الزراعي في اليمن المستخدِم الرئيسي لموارد المياه الجوفية، حيث يستهلك حوالي 90% من إجمالي الاستهلاك، ولا يساهم سوى بأقل من 20% في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لأن ما يزيد عن 50% من المياه المستخرجة من جوف الأرض تذهب لريِ القات.
أما نسبةُ الاكتفاءِ الذاتي من الغذاءِ فهي أقلُّ من 15%، ما يعني أنّ اليمن ليس بمقدورِه إطعام سكَانه إلا بالاعتماد على الخارج.
ويبلغ الطلب السنوي على المياهِ للاستخدام المنزلي والصناعي والاستهلاك الزراعي حالياً ثلاثة ملايين وتسعَمَائة ألف مترٍ مُكَعَّب في السنة، وهو ما يتجاوز بكثير الموارد المتجددة من كل من المياه السطحية والمياه الجوفيةِ البالغة مليونين وخمسِمائة ألف متر مكعب في السنة.
وطبقاً لدراسة حكومية صادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع اليونيسف، فإن نصيب الفرد من المياه، سنوياً تراجع إلى 85 متراً مكعباً، وهو أدنى من خطِ الفقرِ المائي المطلق، بـ 200 متر مكعب، وأدنى بكثير من المتوسط العالمي، لنصيب الفرد من المياه، والذي يصل إلى سبعة آلاف وخمسِمائة متر مكعب.
قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن يعاني من تراجع مستوى العمل في المرافق الخدمية وانخفاض كبير في تقديم الخدمات، وإلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت الرئيسية والمكاتب الإدارية والمختبرات والآلات والمعدات، أدّت أزمة الكهرباء وخصوصاً نقص الوقود إلى تقويض قدرة المنشآت على تشغيل أصول المياه والصرف الصحي بشكل فعّال.
تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 15.4 مليون يمني بحاجة إلى الدعم للوصول إلى احتياجاتهم الأساسية من المياه والصرف الصحي، من بينهم 8.7 مليون شخص في حاجة ماسّة.
ولا يزال الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي يمثّل أولوية قصوى في اليمن، حيث يوجد أدنى نصيب للفرد من المياه على مستوى العالم، إلى جانب ندرة المياه والأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية التي وصلت إلى مستويات حرجة.
وتعد التكلفة العائق الرئيسي أمام الوصول إلى المياه، حيث يعتمد أكثر من 17% من الأسر على المياه المشتراة أو المنقولة بالشاحنات والتي زادت تكلفتها بنسبة 25%.
وتعدّ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية من الصراع وآثار تغيّر المناخ والمخاطر الطبيعية وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية واضطّراب الواردات خاصةً الوقود من العوامل الرئيسية، إذ يضطّر اليمنيون إلى اللجوء لممارسات التأقلم السلبية التي تزيد بشكل كبير من مخاطر سوء التغذية وتزيد من عبء الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتفشّي الأمراض مثل الكوليرا وحمّى الضنك.
ويقّدر البنك الدولي تكاليف إصلاح وإعادة إعمار قطاع المياه والصرف الصحي ما بين 763 و932 مليون دولار.
وتأتي صنعاء في المقدّمة من حيث أعلى نسبة من احتياجات إعادة الإعمار تقدّر بحوالي 196 مليون دولار على مدى خمس سنوات، تليها عدن (159 مليون دولار) وتعز (460 مليون دولار).
خلاصة
تنعكس جودة البنية التحتية في بلدٍ ما بشكل متكامل على انخفاض كلفة إنتاج تلك السلع والخدمات، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها وزيادة الطلب عليها، وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار والنشاط التجاري، مما يعني خلق مزيد من فرص العمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويحدث العكس تماماً في ظل غياب أو سوء البنية التحتية من حيث عدم تكاملها، أو رداءة جودتها، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس، على انخفاض حجم الاستثمار، ويتبعه غياب الاستقرار، كنتيجة لزيادة البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي.
مسار إعادة التعافي، للاقتصاد اليمني، وتحقيق الاستقرار في مختلف الجوانب، قد يبدو من الأشياء بعيدة المنال، في ظل الاختلالات الكبيرة التي ضربت أهم الركائز الحيوية، والبنية التحتية في البلاد، وفاقمت من تدهورها، إلى جانب ما كانت تعاني منه قبل الحرب من هشاشة وضعف في قواعدها الأساسية، التي تعد نقطة الانطلاق نحو البناء والتنمية، وتحقيق تطلعات الشعوب.
دراسة الاحتياجات الملحة التي تعيق عملية التنمية، قد تُشكل ضرورة قصوى، من أجل معرفة جوانب القصور والثغرات، لتجاوز مرحلة الانهيار والفشل والبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار المعيشي، وتفادي انزلاق البلاد، إلى براثن الفشل والانهيار، بيد أن تحقيق هذه الأهداف، لن تأتي بين عشية وضحاها، سيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وهي بحاجة إلى مراحل طويلة من وضع الدراسات والخطط، والبدء في وضع المعالجات وإصلاح الاختلالات، في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية.



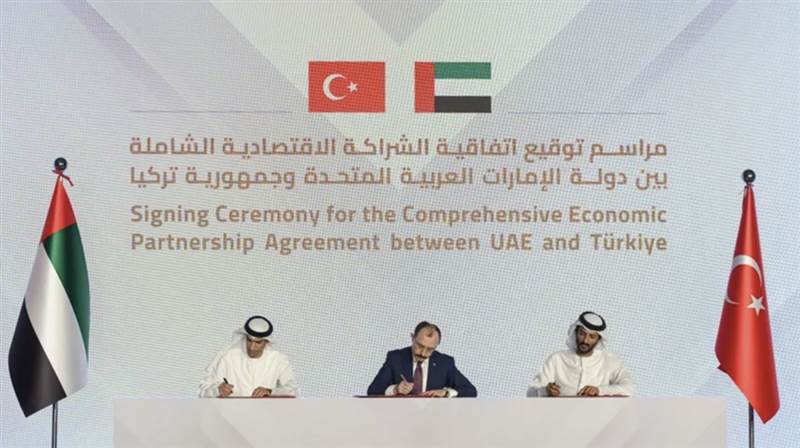





















التعليقات