الحرب العالمية الثالثة.. لماذا؟ ومتى؟
أهميَّة الحرب في السياسة والاقتصاد:
تعدُّ الحرب أكثر الأدوات تأثيرًا في خلق مزيد مِن السلطة والنفوذ، خصوصًا لتلك الدول التي تتمتَّع بقدر أكبر مِن القوَّة العسكرية والأمنية، بما يؤهِّلها للفوز بحروبها التي ستخوضها. فقد ظلَّت القوَّة هي الأداة الأنسب لقمع الخصوم وردع المنافسين، وإبقاء الجميع في إطار الهيمنة والتحكُّم.
كما أنَّ الحرب تعطي للسلطة مبرِّرات الاستبداد في الداخل، وقمع الخصوم وردع المنافسين في الداخل أيضًا. لهذا يلجأ المستبدُّون عادة لخلق حالة مِن الحرب والصراع، بما يمكِّنهم مِن عسكرة الدولة وإحكام القبضة الأمنية، وإسكات المخالفين والمعارضين.
أمَّا اقتصاديًّا، فالاقتصاد انعكاس للسياسة، فكلَّما امتدَّت السلطة وازداد النفوذ كلَّما امتدَّت مجالات الاقتصاد وازدادت الأرباح، خصوصًا الاقتصاد اللَّصيق بالحرب والدولة. وعبر التاريخ كان رجال السلطة والثروة في تحالف دائم، في السلم والحرب، يجنون الأرباح ويتقاسمونها على صعيد واحد. وربَّما مثَّلت الحرب وسيلة أنسب لرجال السلطة لإعادة هيكلة قوى الاقتصاد المحلِّية أو الإقليمية أو الدولية بما يوافق رغباتهم وأطماعهم.
وعليه، فإنَّ رجال السلطة والثروة هم مَن يقرِّرون إشعال الحروب أو اطفاؤها، وفقًا لمعايير الربح والخسارة التي يرونها، خاصَّة إذا امتلكوا القدرة في الحالين. وهذا ما يتجلَّى في حروب العصر الحديث الاستعمارية، والتي قادها العرب سعيًا وراء الثروات والنفوذ واغتصاب الشعوب مقدَّراتها وأوطانها وقرارها. إذ باتت الحرب حاضرة بقوَّة ضمن أجندات الدول الغربية، وهو ما جعلها تتحوَّل إلى اقتصاديَّات عسكرية بدرجة رئيسة، تسعى إلى احتكار مصادر الطاقة والثروات الطبيعية والصناعات العسكرية المتفوِّقة والتقنيَّات العسكرية والأمنية ووسائل النقل الدولية والاستثمارات الكبرى عبر العالم.
وقد كانت أوربَّا -ولا زالت- رائدة الرغبات الاستعمارية التوسُّعية عبر العالم، نظرًا لرغبة شعوبها في التمتُّع بكلِّ سبل ووسائل العيش الممكنة، ولو كلَّف ذلك نهب خيرات الشعوب وانتهاك حقوقها واحتلال أوطانها. فعجلة الاستعمار الأوربِّي المحمومة لم تتوقَّف منذ تطلُّعات الدولة الرومانية، بل وربَّما أسبق مِن ذلك. بل إنَّ رغبات الولايات المتَّحدة الأمريكية الاستعمارية امتداد لهذه المطامع، فالولايات المتَّحدة وريثة هذه النزعة الاستعلائية والاستبدادية، إذ هي بالأساس قامت على ذلك.
وعبر التاريخ الإسلامي، كانت معظم التهديدات الخارجية قادمة مِن أوربَّا، عبر البحر الأبيض المتوسِّط، بل ومِن خلال الالتفات على قارة أفريقيا وصولًا إلى جنوب شرق آسيا، لمحاصرة العالم الإسلامي. ولم يشكل المشرق أيَّ تهديد يذكر للدولة الإسلامية، إلَّا في مرحلة تاريخية وجيزة سرعان ما انقضت، ألا وهي الغزو التتري المغولي للعالم الإسلامي. وإذا ما تتبَّعنا جغرافيا العالم الإسلامي سنجد أنَّ الإسلام استقرَّ في الجزيرة العربية، وشمال أفريقيا، وفي العراق والشام والأناضول، وفي فارس وما وراء النهر إلى آسيا الوسطى، وكذلك في جنوب شرق آسيا. وما تهدَّد الوجود الإسلامي في هذه المناطق تهدَّدها على الصعيد المحلِّي، لا على الصعيد الكلِّي، فيما ظلَّت أوربَّا حاملة لأحقادها التاريخية ونزاعاتها الاستعمارية تجاه العالم الإسلامي مِن شرقه إلى غربه.
أهميَّة الحرب في الأديان والثقافات:
لا تقتصر أهميَّة الحرب على صعيد السياسة والاقتصاد، بل تتجاوزها إلى صعيد الأديان والثقافات. فقد نصَّت الأديان السماوية على الجهاد كفريضة ربَّانية لمقاصد سامية ونبيلة، هي: ردع المعتدين، وقمع البغاة، وكسر هيمنة الجبابرة المستبدِّين الذين يحرمون الناس مِن حرِّيتهم الدينية، وإرهاب الطامعين المتربِّصين، وإخضاع الخارجين على القانون والمفسدين في الأرض، وإقامة العدل. وهي فريضة مرتبطة بقيام المجتمع المسلم، واستقلاله بوطنه ودولته.
والأديان السماوية تنطلق في سنِّ فريضة الجهاد مِن رؤية واقعية لعالم البشر، حيث يطغى عليه المطامع والنزوات لأشخاص مسكونين بشهوة السلطة والثروة، ولديهم القدرة لفرض إرادتهم على جموع البشر بطرق مختلفة، ثمَّ تحويل تلك الجموع إلى جنود مقاتلين مِن أجل مطامعهم ونزواتهم. فمعظم الدول عبر التاريخ لم تمثِّل السلطة المهتدية الراشدة العادلة، بل مثَّلت السلطة الضالة الغاوية الظالمة، ومِن ثمَّ المتوحِّشة والمفسدة في الأرض: ((وَإِذ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجعَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا وَيَسفِكُ الدِّمَاءَ)).. الآية، البقرة: 30. وبالتالي، كان الصراع ضرورة لقمع هذه القوى المتوحِّشة وترويضها، وإيجاد بديل عنها تأوي إليه أفئدة المستضعفين وأرواح الطيِّبين.
غير أنَّ هذه الفريضة الدينية استحالت لدى كثير مِن الطوائف التي تفرَّقت في دينها إلى وسيلة لإدارة خلافاتها مع الآخرين، نصرة لآرائها واجتهاداتها واهتماماتها الخاصَّة، وسعيًّا وراء احتكار كلمة الدين ووجاهته فيها، حتَّى باتت الحروب تشتعل لأغراض طائفية وحاجات مذهبية. وكان أبرز هذه الصراعات ما وقع بين طوائف النصارى وشيعهم، حين كفَّر بعضهم بعضًا، واستحلَّ بعضهم دماء وأعراض وأموال بعض، في صراعات جرَّت على أتباع المسيح الكثير مِن ويلات الحروب. وشيئًا فشيئًا تسلَّل هذا الداء للعالم الإسلامي، حين نشأت الفرق والطوائف وتعدَّدت الدول والممالك، وأصبح القتال داءً داخليًّا في الأمَّة؛ وإن بحدِّة وتطرُّف أقلَّ ممَّا هو عليه لدى النصارى.
عدا عن ذلك، فإنَّ الثقافات البشرية المختلفة اعتمدت على القوَّة كمبدأ للعيش والتدافع، في ظلِّ التنافس والصراع على الموارد والثروات والهيمنة. خصوصًا في ظلِّ ندرة هذه الموارد والثروات أحيانًا. وهذا بدوره صبغ الآداب والفنون والحكم والأمثال، ما جعل الحرب حاضرة في ميراث الشعوب بشكل معمَّق وكبير، ومِن خلال الأساطير والروايات. فثقافة “الحرب” حاضرة في المصطلحات والصور في الذاكرة الجمعية للشعوب، بدون استثناء. على أنَّ لكلِّ شعب فلسفته في تبرير تلك الحروب التي يتبنَّاها، وإضفاء القداسة عليها، لتبقى في وعي الأجيال حاضرة ومؤثِّرة.
في العصر الحديث، تعدُّ الأفلام السينمائية التي تتناول الحرب مِن أكثر الأفلام تداولًا ومشاهدة، بغض النظر عن زاوية النظر وطبيعة التناول وسياق السرديَّة. بما في ذلك حرب النجوم، التي تفترض وجود حرب كونية مع كواكب ومخلوقات أخرى خارج الأرض. وهو ما يشير إلى سكون الحرب في وعي الشعوب بمختلف ثقافاتهم وأديانهم وأعراقهم، وشعورهم بكونها الحقيقة التي تلازم تاريخهم كمجتمعات وشعوب. والغريب في الأمر هو أنَّ الحرب تحتلُّ مكانة في أفلام الكرتون المدبلجة الخاصَّة بالأطفال وإن بلغة أخف وطأة مِنها في الأفلام السينمائية للكبار، في محاولة لإشباع الأجيال مِن غريزة العنف والقوَّة التي تحتاجها الشعوب في أوقات الصراع، رغم كلِّ الأحاديث المشبعة بشعارات السلام والمحبَّة على الصعيد الإعلامي.
هذا الحضور للحرب في الأديان والثقافات جزء مِن حقيقة الحرب كظاهرة إنسانية عابرة، لا يمكن القفز عليها.
عالم بلا حرب.. عالم بلا سلام:
منذ القتلة الأولى، التي ارتكبها أحد ابني آدم ضدَّ أخيه، بات القتال والقتل ظاهرة اجتماعية، أخذت في التطوُّر والنمو، والتوظيف متعدِّد الغايات، حتَّى باتت نشاطًا بشريًّا مستقلًا تقوم عليه المجتمعات والدول، ويتفرَّغ له حشد كبير مِن الناس، وتبذل له الجهود، وتبنى له المنشآت، وتعدُّ له الآلات والوسائل، وتصرف فيه الأموال الكثيرة. ومَن قرأ التاريخ وأحداثه سيجد أن فترات السلام فيه كانت فترات استثنائية ونادرة، وأنَّ الغالب عليها صفحات العنف والفتك والدماء، وتعاقب الدول وصراع المجتمعات.
ورغم ما يسوَّق سياسيًّا وإعلاميًّا منذ الحربين العالميَّتين -الأولى والثانية- عن السلام العالمي إلَّا أنَّ هذا الحلم ظلَّ كذبة كبرى لا واقع لها، لأنَّه حلم ينافي كلَّ حقائق الوجود ومعطيات التاريخ. فقد شهد العالم منذ عام 1945م حروبًا عدَّة شملت معظم جغرافيا الأرض، وهي وإن لم تكن حروبًا عالمية إلَّا أنَّها ارتبطت بمصالح القوى الكبرى وتصارعها وتنافسها على الموارد والنفوذ. وهو ما يفسِّر بقاء جهود الدول للتسلَّح في وتيرة متصاعدة ومتَّسعة، وتضخُّم ميزانيَّات الدول الدفاعية. والدفاعية هنا اصطلاح ناعم لا يعكس حقيقة أنَّ هذه الميزانيَّات تصرف لأغراض الحرب بالأساس، وليس الدفاع فالدفاع لا يتطلَّب هذا القدر مِن التسابق ومحاولة امتلاك الأسلحة المتفوِّقة وذات الدمار الشامل، والقادرة على الوصول إلى أنحاء العالم بوقت أقل وقوَّة تدميرية أقوى!
بالتالي، فإنَّ أكذوبة “السلام” لم تتحقَّق، وظلَّت نوعًا مِن أنواع التخدير الذي تستخدمه الدول الاستعمارية لإفقاد الشعوب المستهدفة في وعيها، وجعلها خاملة وغير متهيِّئة لأيِّ عدوان يقع عليها مستقبلًا. فإذا ما استيقظت قبل ذلك وجدت أنَّ بينها وبين دفع العدوان عن نفسها خرط القتاد، وأنَّه لا بدَّ لها مِن الخضوع لأعدائها والاستسلام لإرادتهم إذا رغبت في السلامة، وليس السلام.
لقد شهدت حقبة “الحرب الباردة” سبق تسلُّح محموم بين الشرق والغرب، وسعيًّا في توسيع دائرة النفوذ والتأثير، وفي الإمساك بأكبر قدر مِن الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والثروات. ومع سقوط الاتِّحاد السوفييتي لعوامل ذاتية وموضوعية وظرفية، كان الغرب قد تهيَّأ ليكون القطب الأوحد المتزعِّم للعالم دون منازع. ونتيجة لتغلُّبه في معركة “الحرب الباردة” ذهب بعيدًا في محاولته لاحتكار النفوذ والثروة في العالم منذ عام 1990م، دون مراعاة لسنن الاجتماع على صعيد الشعوب والدول والثقافات. غير أنَّ هذا التوجُّه المستبدَّ الطاغي أوجد ردود فعل طبيعيَّة مِن قبل الدول الكبرى الأخرى في العالم، خصوصًا وأنَّ هناك ممانعة عالمية برزت ضدَّ الهيمنة الغربية الرأسمالية الطاغية، وإخفاقات أصابت المعسكر الغربي وهو يحاول فرض هيمنته بالحديد والنار (كما جرى في العراق وأفغانستان).
وتأسيسًا على هذه الممانعة العالمية، والإخفاقات التي أصابت المعسكر الغربي الرأسمالي، أخذت دول كروسيا والصين للعمل على مزاحمة القطب الغربي، والذي تمثِّل الولايات المتَّحدة رأس الحربة فيه، في حين تمثِّل أوربَّا عصا الحربة التي تقف وراءه. وقد شجَّع هذا التنازع بين هذه الأقطاب دولًا أخرى للمطالبة بعالم أكثر عدلًا، بعيدًا عن احتكار السيادة استبدادًا في عالم متنوِّع الأعراق والأديان والثقافات والبيئات، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، كإيران وتركيا والبرازيل والاتِّحاد الأفريقي وغيرها. وهذا التوجُّه يخيف المعسكر الغربي، ويقلق قادته على الصعيد السياسي والاقتصادي والديني؛ ويفرض عليهم مواجهة هذه الموجة مِن الطموح قبل أن تصبح تهديدًا حقيقيًّا لمصالحهم ونفوذهم في العالم.
الحرب المتحكَّم بها:
يعرف الغرب قبل غيره، وهو الذي ذاق ويلات الحربين العالميَّتين، بأنَّ الحروب ليست نزهة استمتاع، وأنَّ كلفة الحروب اليوم باتت باهظة في ظلِّ التقدُّم العسكري والتقني للأسلحة الفتَّاكة للجيوش، وتعدُّد طرق الإضرار بالخصم وإصابته في مقتل، لذلك فهو يسعى إلى خلق حروب ضدَّ خصومه متحكَّم بها، بحيث تظلُّ تحت السيطرة. وما رأيناه في حرب أوكرانيا، وما هو حاصل مع عدوان إسرائيل على غزَّة، يشير إلى وجود تحالف غربي كبير يقف وراء الحربين، يتستَّر بلافتات مختلفة، لكنَّه هو ذاته، يقف بقوَّته وجبروته وثرواته وإمكاناته خلف أوكرانيا ضدَّ روسيا، وخلف إسرائيل ضدَّ إرادة شعب فلسطيني أعزل، سيُمثِّل انتصاره شرارة تحوُّل وتغيُّر في المنطقة. لهذا عمدت الولايات المتَّحدة لتهديد الجميع، وبدون استثناء، مِن التدخُّل، بل حضرت بقوَّتها وقدراتها وتمويلها وراء إسرائيل، في مشهد غير متوقَّع.
هذه الحروب التي يرى الغرب ضرورة إشعالها أو إطفاءها لصالح تسيُّده على العالم، دون مراعاة للقوى العالمية الأخرى، ومصالح الدول والشعوب المختلفة، تجد استنكارًا على المستوى الدولي والداخلي (أي داخل بنيته الاجتماعية)، وهو ما تعبِّر عنه المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والحراك الحقوق والإعلامي النشط، والذي تعمل دول كالولايات المتَّحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا على وأده وحصاره وتغييبه عن الإعلام. ومِن ثمَّ فإنَّ هذا الاستنكار المتنامي نتيجة الوعي الحقوقي، أو الشعور بضياع الأموال لصالح قوى الاستكبار والثراء، أو ثقافة السلام والوئام التي تنشدها المجتمعات، سيدفع السلطات الحاكمة في تلك الدول الغربية إلى مزيد مِن الاستبداد والقبضة الأمنية، بل وربَّما إلى إحداث رهاب مجتمعي تجاه السلطة، وهو ما باتت بوادره تظهر في قمع المظاهرات وتجريم حرِّية الرأي وملاحقة الناشطين.
كما أنَّ بقاء تلك الحروب في إطار التحكُّم الغربي بها لن يطول، إذ هذه الحروب مؤهَّلة للاتِّساع أو التنامي بشكل دراماتيكي، بفعل أطراف متضرِّرة، أو متطرِّفة ولديها رغبة بارتفاع وتيرة الصراعات، أو بفعل أخطاء تكتيكيَّة تمس وجود أو مصالح أطراف فاعلة ومؤثِّرة. ومِن ثمَّ فلا يستبعد أن تخرج هذه الحروب عن السيطرة، وأن تسبح بؤرة صراعات تجتذب إليها قوى متعدِّدة، بحيث تتشكَّل تحالفات عسكرية وسياسية، وكذلك اقتصادية، للدفاع عن مستقبلها إزاء التغوُّل الغربي في جغرافيا العالم ودوله وشعوبه. وهذه التحالفات بدأت تنسج في الحقيقة مِن وقت مبكِّر، ولولا التباينات الجوهرية بين أركانها لخطت خطوات كبيرة نحو تحالف أكثر إستراتيجية. غير أنَّ المخاطر ستجبر هذه القوى والدول على الانخراط مكرهة في تحالف مصيري إذا ما استمرَّ الغرب في إضعافها ونزع قدراتها العسكرية والاقتصادية، ومحاصرتها حدَّ الإنهاك والانقضاض عليها.
وقراءة المسرح الدولي في ظلِّ هذه المعطيات، وضمن سياقاته التاريخية القديمة والحديثة، وفي ضوء السياسات والثقافات المتصدِّرة للمشهد العالمي -شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، كفيل بإبراز الخارطة المتوقَّعة لميادين الصراع والحرب العالمية الثالثة القادمة، والتي ستكون في مناطق الاشتعال الرخوة، أو تلك التي يمكن توظيفها بالوكالة للقيام بمهام قتالية موجعة للطرف الآخر، إذ مِن الحكمة لجميع الأطراف ألَّا تدور الحرب على أرضه أو في محيطه الجغرافي، ما يرفع كلفة الأضرار عليه. وهنا يمكن القول أنَّ المنطقة العربية والإسلامية الممتدَّة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب هي الأنسب لهذه القوى العالمية التي ستخوض حربها المستقبلية لتكون ميدانًا للمعركة الفاصلة، ولأنَّ المتغلِّب عليها سيحوز ثرواتها ومضايقها ومواردها الطبيعية المختلفة، وهو ما سعى له الاستعمار القديم، وخصوصًا الاستعمار البريطاني.
ختامًا..
في حين يرى المعسكر الغربي أنَّ الحرب هي الوسيلة الأنسب لإخضاع القوى المناوئة له، والتي تنازعه سيادة العالم، مِن منطلق إيمانه بقدراته السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، فإنَّه سيحمِّس تلك القوى للدفاع عن ذاتها ووجودها ومصالحها، لا على سبيل الرؤى الأحادية ولكن مِن منطلق تحالف عالمي يقاوم المعسكر الغربي، وسواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن. وبالتالي، فإنَّ حقيقة أنَّ العالم يتهيًّأ لحرب عالمية ثالثة حقيقة لا مفرَّ مِنها، إن على أساس إرادة المعسكر الغربي الاستعلائية المستبدَّة، أو على أساس رغبة القوى الأخرى بالانعتاق والحضور والتحرُّر مِن هذا الاحتكار.
القضية اليوم هي إلى أي مدى يمكن أن تدار الحرب العالمية الثالثة بالوكالة، أو بأقل التكاليف، كما يفعله المعسكر الغربي اليوم ضدَّ روسيا في أوكرانيا، وضدَّ العالم الإسلامي بالثورات المضادَّة والقوى الطائفية الإيرانية والكيان الصهيوني المحتل، وضدَّ الصين مِن خلال حصار اقتصادي يستهدف أسواقها وطرق التجارة العالمية الخادمة لها. والمؤكَّد أنَّ الغرب لن يستطيع الاستمرار في تجنُّب الحرب خصوصًا وأن الوقت يمضي لصالح خصومه وليس لصالحه.
فالحرب العالمية الثالثة قادمة، وضرورية للجميع، وضمن معادلات التوازن الكوني الطبيعي، والسنن التاريخية، وبقي فقط الإعلان عن شرارتها الأولى.
نقلاً عن موقع "يمن ونيتور"











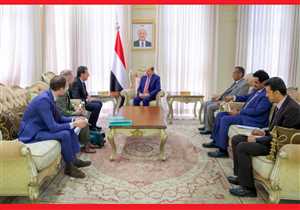














التعليقات